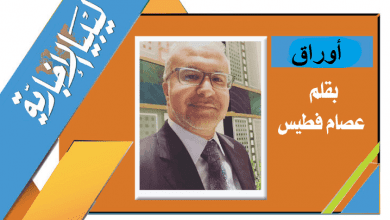الفرص الصحية الضائعة

منذ تشكلت الدولة الليبية الحديثة ومنذ تدفق النفط وفتح أمام البلاد أفق غير مسبوق من الإمكانات ، كانت الصحة واحدة من أعدل الفرص وأوضحها لبناء دولة قوية عادلة ومتماسكة تضع الإنسان في قلب مشروعها الوطني ولم تكن ليبيا تفتقر إلى المال ولا إلى الزمن ولا إلى القدرة على الاختيار. كانت تملك اللحظة والمورد والمجال لتؤسس نظام صحي حديث وتعليم طبي راسخ ، ومدرسة وطنية في الطب والتمريض والقوى العاملة الصحية المتخصصة والإدارة الصحية قادرة على التطور والاستمرار ، وكان يمكن للصحة أن تُبنى بوصفها وظيفة سيادية واستثمار طويل الأمد وليس ملف خدمي طارئ ، وكان بالإمكان أن تتقدم الرعاية الصحية الأولية وأن تُرسخ الوقاية ، وأن تُنشأ مستشفيات جامعية تعليمية وكليات طب مرتبطة بالتدريب السريري والبحث العلمي ، وأن تُدار سلاسل الإمداد الدوائي بعقل الدولة وأخلاقيات وعقيدة الأمن القومي . وكان يمكن أن تُصمم المرافق الصحية بعين المستقبل وأن يُبنى الإنسان قبل المبنى وأن تتشكل منظومة صحية متكاملة وليس مجموعة خدمات متفرقة ، غير أن ما حدث هو العكس وعوملت الصحة كتكلفة وليست كقيمة وعبء إنفاقي وليس حق دستوري فتوسعت المرافق دون تشغيل مكتمل وتكاثرت الكليات دون بيئات تدريب حقيقية وتراكم الكم على حساب النوع ، حتى انفصل التعليم الطبي عن الواقع الصحي وغاب البحث العلمي ، وتحول الطبيب إلى فرد يقاوم النظام بدل أن يكون ثمرة له ، ومع مرور الوقت لم تُعالج الاختلالات بل جرى التعايش معها فتحولت الأخطاء المؤقتة إلى أعراف والاستثناءات إلى قاعدة ، ثم جاء التفتيت فتعددت مراكز القرار ، وتفككت وحدة النظام الصحي ، وفقدت الدولة قدرتها على التخطيط طويل المدى ، وعلى ضبط الجودة وعلى حماية الموارد البشرية والمادية . وفي لحظة كان يمكن فيها تصحيح المسار عبر الاستثمار في الإنسان اتُّخذ واحد من أكثر القرارات تكلفة على مستقبل الطب في ليبيا وتم إيقاف الإيفاد إلى الدول المتقدمة ، والاكتفاء بالتعليم الداخلي بصورته المعروفة وبالتخصص عبر مجالس لا تملك من فلسفة التعليم الطبي الحديث ولا من التدريب السريري المنهجي ما يؤهلها لصناعة اختصاصي بمستوى عالمي وخسرت ليبيا بذلك أجيال من الأطباء الذين حُرموا فرص الدراسة في كليات مرموقة عالميا والتعرض لمدارس طبية متقدمة والاحتكاك بنظم صحية ناضجة ، ولا يزال هذا النزيف المعرفي مستمر ، ليس بفعل الهجرة فقط بل بفعل غلق الأبواب أمام التميز ، وفي الوقت ذاته كان العالم يعيد تعريف الصحة وانتقل إلى الوقاية وإلى الكشف المبكر وإلى الطب المبني على الدليل وإلى الرقمنة وإلى التخصص الدقيق وإلى الربط بين الصحة والبيئة والمجتمع ، ولو استُثمرت عائدات النفط وزمن الدولة في هذا التحول لكانت ليبيا اليوم تمتلك نظام صحي استباقي تنبؤي رقمي قادر على إدارة الأمراض المزمنة والأوبئة والسرطانات والأمراض النادرة وعلى توفير خدمات تأهيلية وتلطيفية تحفظ كرامة الإنسان حتى في أشد لحظات ضعفه ، واليوم حين ننظر إلى الوضع الصحي الليبي لا ينبغي أن نسأل فقط لماذا تدهور؟ بل السؤال الأعمق هو كم كان يمكن أن يكون مختلفا؟ وكم من الأرواح كان يمكن إنقاذها؟ وكم من الكفاءات كان يمكن تكوينها والحفاظ عليها؟ وكم من المعاناة كان يمكن تفاديها؟ إن ما يضاعف الألم ليس حجم الانهيار بل حجم الإمكان الذي كان متاح ، فليبيا لم تفشل لأنها حاولت وفشلت بل لأنها لم تُحسن استثمار الفرصة حين كانت سانحة ، وضاعت الفرص حين لم يُحتكر الدواء كقضية سيادة وحين تُركت سلاسل الإمداد للفوضى وحين تكدست قوى عاملة لا علاقة لها بالمهن الصحية مقابل نقص حاد في التخصصات الحيوية ، وحين هاجرت الكفاءات لأن النظام لم يعد قادر على احتضانها . وضاعت حين لم يُربط التمويل بالنتائج ولم تُبن مستشفيات جامعية حقيقية ، ولم تُصمم الكليات والمرافق لتكون حاضنات علم ومعرفة ، بل مجرد هياكل تؤدي وظيفة شكلية . إن ما نشهده اليوم من تراجع في الخدمات الصحية وتدن في الجودة وضرب للعدالة الصحية والاجتماعية ليس قدر محتوم بل نتيجة مباشرة لسلسلة من القرارات المؤجلة والخيارات الخاطئة والفرص المهدورة ، والأخطر من التراجع نفسه هو الاعتياد عليه لأن الاعتياد هو الوجه الآخر للانهيار ، والحق في الصحة ليس امتياز بل جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع ، وحين تُخل الدولة بهذا الحق أو تتراخى في حمايته فإنها لا تُضعف قطاع خدمي فحسب بل تُقوض شرعيتها الأخلاقية وتفتح الباب أمام اللامساواة وتضرب فكرة العدالة في صميمها ، إن قراءة هذا التاريخ ليست للبكاء على ما فات بل لإيقاف النزيف ومنع الغرق أكثر في كل ما يدفع إلى التراجع ، فما تبقى من الإمكان لا يزال كافي إن وُجد الوعي ووُجد القرار ووُجدت الشجاعة لإعادة الاعتبار للصحة بوصفها حق عام وركيزة دولة ، فالصحة في النهاية ليست مرآة المرض فقط بل مرآة الدولة نفسها ، وحين تصدق الدولة مع صحة مواطنيها تبدأ أولى خطوات تعافيها الحقيقي … كيف أضعنا زمن الإمكان؟
د.علي المبروك أبوقرين